عمليات الترحيل في عام 1915 (1)
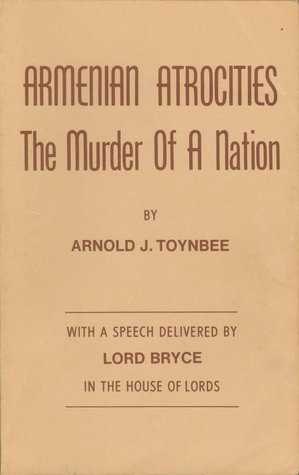
(الإجراءات)
سيكون من المستحسن هنا أن نقدم ملخصاً سريعاً عن الأحداث لتوضيح الائتلاف الجوهري للمخطط الذي يبين الإجراءات هو أكثر بشاعة من تصعيد الجرائم على يد الأكراد والفلاحين ورجال الدرك أو السلطات المحلية، وثمة إثباتات تؤكد أن الحكومة المركزية في القسطنطينية هي التي أعدت وخططت لجميع الإجراءات التي حركت قوى الشر.
لقد أعقب طرد المفتشين العامين وإلغاء الإصلاحات على الفور تعبئة الجيش العثماني من أجل الاشتراك في الحرب، ومنذ تلك اللحظة بدأت معاناة الشعب الأرمني، وكنا قد ذكرنا سابقاً أن الاتحاديين، كانوا قد أصدروا قانوناً يدعو المسيحيين إلى أداء الخدمة العسكرية، كما أن المجندين الأرمن أثبتوا تفوقاً كبيراً وشجاعة عظيمة في حرب البلقان، ولم يكن لقانون الخدمة مفعول رجعي، إذ سمح للأرمن الذين اجتازوا السن القانونية للخدمة العسكرية عند تطبيق القانون بدفع ضريبة الرأس (لكل فرد) كما كان سارياً من قبل اسم (ضريبة عفو من الخدمة العسكرية). وفي عام 1914 فرضت السلطات ضريبة عامة على جميع الذكور في الإمبراطورية الذين تترواح أعمارهم بين العشرين والخامسة والأربعين، ثم سرعان ما أصبحت بين الثامنة عشرة والخمسين بعد فترة وجيزة، وقد طبق هذا القانون على الأرمن شأنهم باقي أفراد الشعب، سواء دفعوا ضريبة الإعفاء السنوية أم لم يدفعوها، كما صودرت المؤن الخاصة. وكان الأرمن مرة أخرى ضحاياها الرئيسيين، إذ كانوا هم كبار التجار وأصحاب المتاجر في البلاد، ولقد كان ذلك إجحافاً كبيراً بحقهم. ولكنه لم يكن بالضرورة نتيجة خطط حاقدة. وباستثناء ما تبع ذلك، فإنه يمكن اعتبار ذلك بكل بساطة من العقوبات المحتومة التي تفرض على شعب شرعت حكومته في القتال دفاعاً عن وجودها.
وعند انتهاء التعبئة العسكرية في تشرين الأول، أعلنت الحكومة الحرب على الحلفاء، وفي كانون الأول بدأت بشن عملياتها الحربية الكبيرة. وقام أنور باشا الذي كان يقود القوات العثمانية الرئيسة بحركة التفاف على القوات الروسية في القوقاز على طول جبهة تمتد من أرضروم وحتى شاطىء البحر الأسود. وقاد خليل بك قوة سريعة عبر حدود أذربيجان، وآثار الأكراد. في حين اتجه جمال باشا إلى جزيرة سيناء باتجاه قناة السويس، وخلال أسبوع أو أسبوعين نجحت الجيوش المهاجمة ووصلت إلى أرداهان بعد كارس، ودحرت الروس من مواقعهم في صاري غاميش، واحتلت تبريز عاصمة أذربيجان. ولكن سرعان ما فشلت الحملة وانتهت بكارثة، ففي الأسبوع الأول من كانون الثاني 1915 تم تدمير فرقتين عسكريتين تركيتين في صاري غاميش، ودحرت باقي الفرق خارج الأراضي الروسية في نهاية الشهر نفسه، وفي 30 كانون الثاني استولى الروس على تبريز، أما حملة جمال باشا على مصر، فقد تأخرت شهراً واحداً، إلا أنها جنت الشيء نفسه، فقد وصل إلى القناة في بداية شهر شباط بعد مسيرة شاقة عبر الصحراء، ليعود من حيث أتى، وذلك بعد الهجوم الإجهاضي الذي شن في الليل ضده، لذا انصرف هم الأتراك عن الهجوم إلى الدفاع عن جبهاتهم المتداعية، وكان هذا الفشل بمنزلة ضربة مؤلمة للاتحاديين، لأنها قضت على نصف الآمال التي دفعتهم للاشتراك في الحرب، وقد انقلب التفاؤل الشديد في الشتاء إلى خيبة وكآبة شديدتين، ونتيجة لتلك الظروف الجديدة، فقد دخل اضطهاد الأرمن مرحلة ثانية أكثر إيجابية.
ومن أجل ذلك، صدر مرسوم يقضي بتجريد جميع الأرمن من السلاح، وأخرجوا من صفوف الجيش، وأعيد تشكيلهم في كتائب للعمل، كان من مهامها بناء التحصينات وشق الطرق، وقد ترك أمر تجريد السكان المدنيين من السلاح للسطات المحلية، وبدأت في كل مركز إداري فترة من الذعر، وطالبت السلطات تسليم عدد معين من السلاح، وكان الذين لا يسلمون سلاحاً يخضعون للتعذيب بطرق وحشية في معظم الأحيان، أما الذين كانوا يسلمون سلاحاً، فكانوا يشترونه من جيرانهم المسلمين، أو يحصلون عليه بطرق أخرى، وكان يزج في السجن بتهمة التآمر على الدولة، وكان من بين هؤلاء عدد قليل جداً من الشباب، لأن معظهم كان قد دعي لأداء الخدمة العسكرية، بل كانوا من المسنين الذين كانوا يسعون للحصول على قوتهم ورزقهم، وسرعان ما اتضح أن عملية البحث عن السلاح، لم تكن سوى ستار استخدم لإبعاد الأرمن عن قادتهم وزعمائهم، وقد سبقت مجازر 1894-1896م إجراءات مشابهة، وساد لدى الأرمن شعور بالخوف من حصول شيء خطِر، وقد كتب أحد الشهود الأجانب عن هذه الحوادث فقال: “في إحدى ليالي الشتاء، أرسلت الحكومة جنوداً إلى جميع بيوت الأرمن في المدينة، وقرعوا أبواب البيوت وطلبوا تسليم جميع الأسلحة، وقد أدخلت هذه الإجراءات الفجيعة في القلوب الآمنة”.
وقد صح الاستدلال المرعب، لأن المرحلة الثانية من الاضطهاد استمرت من دون توقف، ودخلت مرحلتها الثالثة والأخيرة، ومن الواضح أن المسلسل كله من صنع الوزارة في القسطنطينية قبل طلب الأسلحة أو مع بداية زج أول أرمني في السجن، ويرجع التنظيم المحكم على الأقل إلى شباط من عام 1915، وبالفعل فإن الاستعدادات الدقيقة التي تمت حتى تاريخ 8 نيسان، وهو تاريخ أول عملية ترحيل في زيتون تثبت هذا التاريخ على الأقل. إن تأكيد هذه الوقائع التاريخية شيء بالغ الأهمية، لأنها تدحض محاولات المتأولين بعدم ربط المرحلة الأخيرة بالمراحل السابقة لها، وبأنها إجراء طارىء أملته الأحداث العسكرية في الربيع.
في الحقيقة، كان الوضع يشتد احتداماً وتوتراً قبل الربيع. ففي القرى النائية رافقت عمليات التفتيش عن الأسلحة أعمال عنف صارخة. فقد قامت دوريات الدرك بقتل الرجال وانتهاك أعراض النساء، وإحراق البيوت، وتكررت مثل هذه الأعمال البشعة بصورة خاصة في إقليم وان، حيث بدا أن الجنود كانوا ساخطين ومستائين نتيجة الهزائم الأخيرة التي تكبدوها. وبالتأكيد أثارت مشاعرهم وحشية الوالي جودت بك الذي عاد لممارسة واجباته الإدارية بعد حملته الفاشلة على الحدود، وقد تمثل العنف المتزايد في قتل أربعة من الزعماء الأرمن، عندما كانوا في طريقهم من المدينة إلى منطقة نائية بناء على طلب جودت بك نفسه للحفاظ على الهدوء بين الأرمن المحليين، وجيرانهم الأتراك المسلمين، وبعد أن رأى الأرمن في مدينة وان مصير إخوانهم في القرى المجاورة، بدؤوا يتخذون الاحتياطات اللازمة للدفاع عن أنفسهم عند الضرورة. وقد برر ذلك لهم جودت بك، بعد أن قام بتطويق ضاحية أيكسدان (أي الحديقة) وهي إحدى ضواحي وان، حيث كان يقطن معظم السكان الأرمن، وفي 20 نيسان أطلق جودت بك قواته عليهم، وبدأ الأرمن في وان القتال دفاعاً عن أنفسهم ضد الهجوم الذي قامت به الحكومة من أجل قتلهم، تلك الحكومة التي كان من المفترض أن تطبق القانون وتنشر السيادة في البلاد. وحدثت سلسلة الأحداث نفسها في زيتون، إذ رافق أعمال التفتيش عن السلاح تكثيف كبير للقوات في المدينة، ولم تبدأ المرحلة الأخيرة بارتكاب المجازر فحسب، بل كذلك بطرد الدفعة الأولى من السكان، وقد حصل ذلك في 8 نيسان، أي قبل هجوم جودت بك على وان باثني عشر يوماً، وقد سبق الوضع العسكري الجديد كلتا الحادثتين. وفي الواقع، فإن اليأس الذي أصاب السكان المدنيين الأرمن في وان، كان الحافز لقيام الروس بمبادرتهم، فقد اخترقت قوات روسية ترافقها مجموعة من المتطوعين الأرمن الروس المدينة من طرف مدينة بيازيد، وأنقذوا المدافعين عن المدينة بتاريخ 19 أيار أي بعد أن دام حصارهم شهراً كاملاً، وهكذا فقد ارتدت استراتيجية الالتفاف على الأتراك أنفسهم، واحتلت قوة روسية أخرى أورمية في 24 أيار، وطردت آخر فلول الأتراك والأكراد من أذربيجان، وفي الوقت نفسه، كانت قوة بريطانية أخرى تشق طريقها باتجاه نهر دجلة. وبينما كانت الأحداث تأخذ هذا المنحى الخطِر في الشرق، كان وسط الإمبراطورية مهدداً بالهجوم على الدردنيل، وفي نهاية أيار 1915م، كانت النظرة العامة يشوبها اليأس مثلما كانت عليه في الأيام العصيبة من عام 1912، ولكن يجدر التأكيد مرة أخرى على أن المرحلة الأخيرة من هذه الإجراءات التي اتخذت ضد الأرمن، كانت قد بدأت قبل ظهور التهديدات والأخطار العسكرية الحادة هذه في الأفق. ومن الجائز أن تكون الضائقة العسكرية التي وجد الأتراك الاتحاديون أنفسهم فيها في ربيع 1915م، هي التي عجّلت في تنفيذ مخططاتهم المرسومة التي تتعلق بالأرمن، ولكن لم يكن لها تأثير يذكر على نشوئها.
وفي 8 نيسان بدأت المرحلة الأخيرة من المخطط، وطبقت الإجراءات نفسها التي اتخذت في زيتون، وفي المراكز الأرمنية الأخرى في أرجاء الإمبراطورية العثمانية، ففي يوم معين، وفي جميع القرى والمدن (تظهر التواريخ تسلسلاً مهماً) خرج المنادي في شوارع المدن والقرى ليعلن أنه على ذكر أرمني أن يحضر إلى دار الحكومة، وفي بعض الأحيان كان الجنود أو الدرك الذين كانوا يقتلون أي أرمني يرونه في الشارع، هم الذين يصدرون هذه الأوامر. وهذا يذكرنا بما حدث في 1894-1896م. ولكن طلب الحضور أمام دار الحكومة كان يعتبر مرحلة مبدئية، وحضر جميع الرجال، وهم لا يزالون يرتدون ثياب عملهم، بعد أن تركوا حوانيتهم ومتاجرهم مفتوحة، ومحاريثهم في الحقول، وقطعانهم على سفوح الجبال، وعندما وصلوا إلى المكان المعين لهم، زج بهم الأتراك في السجن من دون أي مبرر، واحتجزوهم هناك يوماً أو يومين، ثم اقتادوهم إلى خارج البلد بعد أن قسّموهم إلى مجموعات، وقيدوهم بالحبال، وساروا باتجاه الجنوب الشرقي، وقالوا لهم: إنهم سيقومون برحلة طويلة إلى الموصل، أو ربما إلى بغداد، وبطبيعة الحال أدخل ذلك الذعر في نفوس الرجال العزّل الذين لم يكونوا يحملون أي قطعة من النقود، أو الطعام، أو اللباس، بل لم يسمح بتوديع عائلاتهم وتصفية أعمالهم، ولم يكن لديهم الوقت الكافي، لكي يفكروا بمحنتهم، إذ قام الأتراك بقتلهم في أول بقعة منعزلة على الطريق. ونفذ الشيء نفسه في الرجال الأرمن الآخرين (الذين تجاوز عددهم المئات، بل الآلاف في المدن الكبرى) والذين زج بهم في السجن خلال أشهر الشتاء بتهمة التآمر أو إخفاء السلاح، على الرغم من ورود عدد من الحالات التي تغاضى فيها الأتراك عن بعض هؤلاء السجناء، وهو شكل من أشكال تأجيل قتلهم، وردت أمثلة عنه أثناء عهد الإرهاب عام 1793 في فرنسا. هذا ما قامت به السلطات المدنية. بيد أنه كان هناك انسجام تام بين وزارة الداخلية التي يترأسها طلعت بك، ووزارة الحربية برئاسة أنور باشا، لأنه في الوقت نفسه، قامت مفارز من الجنود الأتراك بتطويق فرق العمل الأرمنية التي كانت تعمل خلف الجبهة، وأبادوها عن بكرة أبيها.
كما قامت السلطات العسكرية بعمليات تفتيش فورية على السكان المدنيين في بيتليس وموش وصاصون بسبب قربها من مدينة وان ومن القوات الروسية المتقدمة، وتم ذلك باستخدام أساليب عسكرية بمساعدة بعض الأكراد المحليين – عودة أخرى إلى أساليب عبد الحميد – إلا أن تطبيقها اقتصر على المناطق الآنفة الذكر. أما في باقي الإمبراطورية، حيث كانت الإدارة المدنية تقوم بتنفيذ الخطة، فلم يتم التخلص من النساء والأطفال بقتلهم مباشرة كما حدث للرجال، بل كانوا ينتظرون مصيراً وفق تخطيط الحكومة، لا يتمثل في القتل؛ بل في العبودية أو الترحيل.
وبعد قتلهم الرجال، كان الأتراك يتركون فاصلاً زمنياً، يستغرق عدة أيام في كل المدن، ليعود المنادي، ويعلن أنه يجب على جميع ما تبقى من الأرمن الاستعداد للرحيل، في حين كانت تعلق لافتات تحمل هذا الأمر على الجدران[1]، وقد طبق هذا في حقيقة الأمر على النساء والأطفال وعدد قليل من الرجال الذين تمكنوا من الهرب من مصيرهم المحتوم، بسبب المرض، أو العجز، أو الشيخوخة، وكانت السلطات تمنحهم في معظم الحالات مهلة للاستعداد لهذه الرحلة، ولكن هناك انتزع فيها الأرمن من وراء نولهم، أو حتى من أسرّتهم من دون إنذار، وكانت المهلة التي تمنح لهم في كثير من الأحيان وهمية، فكانت عادة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى – وهي فترة لا تكفي أبداً للاستعداد لمثل هذه الرحلة، إضافة إلى ذلك هناك أمثلة كثيرة، خالفت فيها الحكومة وعدها، وطردت السكان قبل الموعد المحدد.
أما بالنسبة للنساء، فكان أمامهن بديل آخر للترحيل، إذ كان بإمكانهن الخلاص من الترحيل إذا ما اعتنقن الإسلام، غير أن تغيير الديانة بالنسبة لامرأة أرمنية عام 1915م كان شيئاً مادياً أكثر من كونه عقيدة، وكان ذلك يتم بطريق الزواج من رجل مسلم، أما إذا كانت المرأة متزوجة (أو أرملة نظراً لعدم بقاء عدد كبير من الأزواج على قيد الحياة خلال هذه الفترة)، فكان عليها أن تنفصل عن أطفالها الذين كانوا يسلمون إلى “دار الأيتام الحكومية”.
ولم يكن أحد متأكداً من ذلك، لأنه لم يكن هناك مثل هذه المؤسسات من قبل، أما إذا لم يتقدم أحد الأتراك للزواج من المرأة التي اعتنقت الدين الإسلامي، أو رفضت معانقة الزوج المتقدم لها، فعندئذ ترّحل هي وأطفالها مع الباقين، مهما عبّرت عن رغبتها في اعتناق الإسلام، وكان الترحيل هو البديل الذي فرض على الأغلبية العظمى.
إن الحكم بالترحيل كان ضربة قاصمة، ومع ذلك، فقد كان على الذين حكم عليهم بالرحيل تمضية أسبوع المهلة الممنوح لهم في نشاط محموم، لكي يحصلوا على ثياب ومؤن ومال استعداداً للرحلة. وقد وضعت السلطات المحلية أمامهم كل عقبة ممكنة، وكانت الحكومة، قد أذاعت بأن نفيهم مؤقت، لذلك منعوا من بيع عقاراتهم أو مواشيهم. وقد مهرت الحكومة ختمها على البيوت المهجورة والأراضي والبضائع، وذلك “للحفاظ عليها لحين عودة أصحابها”، إلا أن المالكين الشرعيين لاحظوا قبل الشروع في رحلتهم، أن أملاكهم التي لم يسمح لهم باستخدامها، كانت قد بدأت الحكومة بتقديمها كهبات للأتراك الذين احتشدوا في منطقة مجاورة، وكانوا على أهبة الاستعداد لشغل منازل الأرمن[2]. وحتى ممتلكاتهم وحاجياتهم الشخصية التي سمح لهم بالتصرف بها، لم تكن ذات نفع كبير لأن جيرانهم الأتراك استفادوا منها واشتروها بأسعار زهيدة جداً، لذا فعندما حان موعد الانطلاق، لم يكونوا مجهزين تجهيزاً جيداً للرحلة.
وقد أخذت الحكومة على عاتقها نقلهم، وفي الحقيقة لم يكونوا في وضع يسمح لهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لأن مكان وجهتهم بقي طي الكتمان، وقد قسّم المنفيون من كل مركز إلى عدة قوافل، تراوح عدد كل منها من مئتين أو ثلاثمئة، إلى ثلاثة أو أربعة آلاف شخص، وكانت ترافق كل قافلة مفرزة من الدرك لحراستها، كما استأجرت السلطات المدينة، أو صادرت عدداً من العربات التي تجرها الثيران، ووضع تحت تصرف كل عائلة عربة واحدة، وهكذا انطلقت القافلة، لقد كانت وطأة بؤس الترحيل شديدة، ولكن سرعان ماحلت محلها الآلام الجسدية، فبعد عدة ساعات من بدء الرحلة أبدى سائقو العربات عزوفاً عن الاستمرار فيها، وعادوا من حيث أتوا، وكان على المنفيين متابعة الرحلة سيراً على الأقدام، ومن هنا بدأ العذاب الجسدي للمنفيين، لأنهم لم يكونوا يسيرون على أرض ممهدة، بل عبر ممرات تسلكها البغال والدواب وفي أكثر المناطق قساوة من حيث الطبيعة في العالم، وكان الفصل صيفاً، وكانت الآبار والينابيع تبعد مسيرة بضع ساعات، وفي أغلب الأحيان كان رجال الدرك يجدون متعة في منع ضحاياهم الفاقدي الوعي من الشرب. لقد كانت الرحلة شاقة جداً حتى بالنسبة لجنود مدربين، ولم يكن أحد من أفراد هذه القوافل لائقاً لهذه المصاعب والمشقات الجسدية، إذ كانت هذه القوافل تتكون من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. وكانت بعض النساء فيما مضى قد عشن حياة رغيدة، وكان على بعضهن حمل أطفالهن الصغار غير القادرين على السير، كما وضعت عدة نساء حوامل وهن في الطريق، ولاقت جميع تلك النساء حتفهن لأنهنَّ كن يرغمن على السير بعد ساعات قليلة من الراحة، كما هلك مواليدهن الجدد، ومات عدد آخر من الجوع والعطش، أو نتيجة إصابتهن بضربة الشمس، أو بالسكتة الدماغية أو نتيجة الإعياء. إن المشاق التي عانتها النسوة اللائي صحبن أزواجهن أثناء انسحاب السير جون مور Sir John Moore إلى كورونا Corunna، لايمكن مقارنتها مع المشقات التي تحملتها النساء الأرمنيات، إذ كانت الحكومة التي حكمت عليهن بالنفي تعرف ما تحمله الرحلة من مشاق جسيمة، كما عمل أتباع الحكومة الذين قادوا القوافل ما بوسعهم لزيادة آلامهن الجسدية، ومع ذلك، فقد كانت تلك المرحلة هي الأكثر سهولة من عذابهن، إذ كان بانتظارهن فظائع أسوأ بكثير ارتكبتها كائنات بشرية مثلهن.
ومنذ اللحظة التي غادرت فيها القوافل البلدة، لم تعد آمنة من ارتكاب الفظائع الشنيعة ضدها، فعندما كانت تمر في إحدى القرى، كان الفلاحون الأتراك يهاجمونها ويسلبونها، وكان الدرك يتسترون على وحشية الفلاحين، كما تستروا من قبل على سائقي العربات الذين تركوها وشأنها، وعندما يصل أفراد القافلة إلى إحدى القرى، كانوا يعرضون وكأنهم عبيد، وكان ذلك غالباً ما يتم أمام نوافذ دار الحكومة، وكان يسمح للأتراك أخذ ما يحلو لهم من النساء، وضمهن إلى الحريم، أما الدرك أنفسهم، فقد أخذوا يفعلون ما يحلو لهم مع الباقيات، وكانوا يرغمونهن على مضاجعتهم، وكنّ يواجهن أعمالاً أكثر فظاعة عند وصولهن إلى الجبال، حيث كن يواجهن قطاع الطرق، الذين أطلقت الحكومة سراحهم من السجون لاعتبارات خاصة يفهمها الطرفان، والذين لم يتغيروا منذ عام 1896، لأنهم كانوا لايزالون يحتفظون بالأسلحة التي كان عبد الحميد، قد وزعها عليهم، ولم يكن في نية الاتحاديين سحبها منهم، بل عادت الحكومة لاستمالتهم بسبب إعلان الجهاد المقدس، لذا فقد كانوا في مأمن، مثلما كانوا قبل عام 1908، كانوا يدركون تماماً المدى الذي سمح لهم به، وماطلب منهم أن يفعلوه. وعندما كانت القبائل (الجتا) تعترض القوافل، كان رجال الدرك يتغاضون عما يفعلونه، بل كانوا يحذون حذوهم، حتى إنه يصعب تحديد من كان له ضلع حاسم في المجازر التالية – لأن قطّاع الطرق هؤلاء، قد جاؤوا لهذا الغرض، وكانت أولى ضحاياهم الشيوخ والصبية وجميع الذكور في القافلة، ماعدا الأطفال الرضع، كما قتلت النساء فيما بعد، وقد كان قتل المرأة، أو أخذها إلى الجبال، يعتمد على نزوة اللحظة، وعندما كانوا يختطفون النساء، كانوا يتركون أطفالهن على الأرض، أو يضربونهم بالحجارة، وإن على المتبقين متابعة المسير، وقد ازدادت وحشية رجال الدرك ضد ضحاياهم، إذ بدا صبر الأتراك قد بدأ ينفد من أجل الإسراع في إنهاء مهمتهم، فكانوا يطعنون النسوة اللواتي كن يتخلفن عن أفراد القافلة بالحراب على الطريق أو يرمونهن من أعلى الهاوية، أو من فوق الجسور، وكان عبور الأنهار، ولاسيما نهر الفرات مناسبة لارتكاب مزيد من الجرائم الجماعية، فعندما كانت النساء والأطفال الذين يعبرون النهر، يقتربون من الضفة الأخرى، كان الدرك يطلقون عليهم النار، ولم يكن لرغبة معذبيهم من حدود، وقد وصلت النسوة اللواتي تمكن من النجاة إلى مدينة حلب، وهن عاريات، بعد أن تمزقت ثيابهن أثناء الرحلة، ولاحظ الذين شاهدوهن، وهن يدخلن المدينة، أنه لم يكن بينهن وجه جميل أو شاب، وبالتأكيد لم تتمكن أي عجوز من النجاة – بل بلغت الشابات الشيخوخة بسرعة نتيجة المعاناة والآلام التي تكبدنها- وكانت الفرصة الوحيدة أمام الواحدة منهن للنجاة، هي ألا تكون على قدر من الجمال، وذلك لكي تفلت من شهوة معذبيها، وأن تكون قوية بشكل يمكنها تحمل مشقات الطريق.
هذه هي قصة المنفيين الذين وصلوا سيراً على الأقدام، بيد أنه كان هناك آخرون من المدن والمناطق الشمالية الغربية الذين تم نقلهم إلى حلب بالقطار، فهؤلاء لم يتعرضوا لوحشية تلك القبائل، إلا أن معاناتهم التي غالباً ماتكون ملأى بالأقذار ومكتظة، وكانت رحلتهم شديدة البطء، وذلك بسبب ازدحام الخطوط بأفواج الأرمن وعبور القوات العسكرية، وعند كل محطة، كانوا ينتظرون أياماً عديدة من دون طعام أو مأوى، بل حتى أسابيع، لكي يصبح الخط آمناً مرة أخرى، ليعاد نقلهم إلى محطة أخرى. ولم يكن الدرك الذين كانوا يرافقونهم أقل قساوة من زملائهم الذين كانوا يرافقون القوافل الأخرى، وعندما كانوا يصلون إلى التقاطع على خط بغداد الحديدي، حيث يجتاز الخط سلاسل جبال طوروس وأمانوس، كان يجب عليهم اجتيازهم سيراً على الأقدام، وهي أكثر المراحل مشقة وصعوبة. وأخذت معسكرات الاعتقال تزداد اتساعاً في محطة (بوزانتي) بداية الخط الحديدي غرب طوروس، وفي محطات غرب طوروس، وفي محطات (عثمانية) و(مأمورة) و(إصلاحية) و(كوتمو) على طرفي سلسلة جبال الأمانوس، وحيث كان المنفيون يبقون لشهور عديدة، وكان الآلاف منهم يموتون من التضور جوعاً ونتيجة الإصابة بالأوبئة، وكان القسم الذي وصل منهم إلى حلب في حالة يرثى لها، مثل الذين قطعوا الرحلة على الأقدام من البداية إلى النهاية.
وكانت مدينة حلب نقطة تجمع لجميع القوافل، وصحيح أن نصف سكان زيتون، كانوا قد أرسلوا باتجاه الشمال الغربي إلى (السلطانية) في مقاطعة قونية، وهي أكثر بقاع صحراء الأناضول سوءاً من الناحية الصحية في شهر نيسان، غير أن السلطات غيرت من خطتها وأرسلتهم من السلطانية إلى الجنوب الشرقي للانضمام إلى المنفيين الآخرين في الصحراء السورية، ومنذ ذلك الحين أصبح من المعروف أن وجهة المنفيين هي الصحراء الجنوبية الشرقية وحلب، وفي مرحلة ثانوية، كانت أورفة ورأس العين مركزين لتوزيع المنفيين.
ووزع عدد من المنفيين الأرمن على مناطق مجاورة لمدينة حلب، مثل منبج والباب والمعرة وإدلب، ولكن يبدو أن هذه المناطق قليلة نسبياً، ولم يكن أحد متأكداً فيما إذا كانت النية معقودة على إبقائهم هناك بصورة دائمة. وتم ترحيل عدد كبير باتجاه جنوب حلب على طول الخط الحديدي السوري. وسمح لهم بالتوقف في مناطق حماة وحمص ودمشق للراحة. كما أرسلت أعداد كبيرة منهم باتجاه الشرق، واستقروا على ضفاف نهر الفرات، واستقر عدد كبير منهم في الرقة، وكانت دير الزور أكبر مركز بعد حلب يستوطن فيه الأرمن، وأرسل بعضهم الآخر إلى الميادين، وهي تبعد مسيرة يوم باتجاه النهر، ويذكر المسافرون المسلمون، أنهم شاهدوا عدداً آخر خلال رحلة دامت ثماني وأربعين ساعة من بغداد، ولم يرد أي دليل على وجودهم في الموصل، أو بالقرب منها، على الرغم من أن الأتراك كانوا يشيعون أنهم سيرسلونهم إلى هناك.
المصدر: مختارات من بعض الكتابات التاريخية حول إبادة الأرمن عام 1915، ترجمة: خالد الجبيلي، اللاذقية – 1995)- شهادة أرنولد ج. توينبي). مقتطف من كتاب (شهادات غربية عن الإبادة الارمنية في الإمبراطورية العثمانية)، إعداد ومراجعة ودراسة: البروفيسور-الدكتور آرشاك بولاديان، دمشق – 2016.
29- نشر البيان الذي أعلن أمر الترحيل، وتبريراته بصورته الكاملة في صحيفة ساترداي إيفننج بوست (Saturday Evening Post) في فيلادلفيا بتاريخ 5 شباط 1915.
30- شوهد هؤلاء المهاجرون المسلمون بشكل خاص في كيليكيا وفي أقاليم أرضروم وطرابزون.
