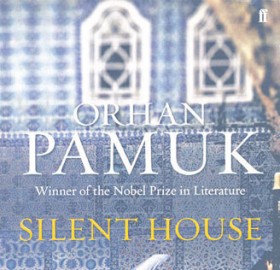Silent House … المجتمع التركي بريشة أورهان باموك
لم يشغل أورهان باموك الناس بتصريحاته النارية حول مذابح الأرمن والأكراد فحسب، بل ملأ الدنيا أيضاً بكتاباته التي تُرجمت إلى أكثر من 34 لغة وقرأها الناس في أكثر من مئة دولة. واحتل اسم باموك عناوين الصحف مجدداً حين فاز عام 2006 بجائزة نوبل الآداب.
عام 1983، نشر باموك روايةSilent House البيت الصامت، التي تناول فيها ما شهدته تركيا من تطورات اجتماعية، وتاريخية، وسياسية نحو أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال قصص سردها على لسان أبطاله الستة، الجدة فاطمة، ابن زوجها غير الشرعي رجب، والأحفاد فارق، مؤرخ فاشل، وأخته اليسارية نيلغون، ومتن، طالب ثانوية يعشق حياة الأثرياء الجدد السريعة ويحلم بالسفر إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن ابن أخ رجب حسن. ينجح باموك في تصوير تلك الحقبة بكل ما فيها من اضطرابات وتغييرات، عاكساً في الوقت عينه خبايا النفس البشرية وخفاياها بأسلوب ممتع. إليكم مقتطفاً من هذه الرواية الشيقة.
رجب يذهب إلى السينما
قلت: «العشاء جاهز سيدتي، هلا تأتين إلى الطاولة». لم تنبث ببنت شفة، بل تسمّرت مكانها متكئة على عكازها. فاقتربت منها وأمسكت بيدها، ثم قدتها نحو الطاولة. راحت تتمتم قليلاً. نزلتُ إلى المطبخ وأحضرتُ صينية طعامها ووضعتها أمامها. فنظرت إليها ولم تمسّ الطعام. فأخرجت محرمتها ومددتها تحت أذنيها الضخمتين وربطتها. فقالت: «ماذا أعددت لنا هذه الليلة؟ لنرَ ما حضرته». فأجبتها: الباذنجان المخبوز. طلبتِ هذا الطبق أمس، أليس كذلك؟. نظرت إليّ فدفعتُ بالطبق نحوها، فراحت تبعثر الطعام بشوكتها، متذمرةً بصوت منخفض. وبعد العبث بمحتوى طبقها قليلاً، بدأت تلتهمه. فقلت لها: «سيدتي، لا تنسي السلطة». ثم توجهت إلى الداخل وجلست لتناول الباذنجان. ولكن ما هي إلا لحظات حتى نادت: «الملح! رجب، أين الملح؟». فعدت إليها ورأيت الملح أمامها مباشرة. فقلت لها: «ها هو». أجابتني: «هذه مملحة جديدة». وتابعت: «لمَ تجلس في المطبخ خلال تناولي الطعام؟». لكني لم أجبها. فأضافت: «سيأتون غداً، أليس كذلك؟
-سيأتون يا سيدتي، سيأتون. ألا تودين رش الملح على طعامك؟
-اهتمّ بشؤونك. هل هم قادمون؟
-سيصلون بعد ظهر يوم غد. لقد اتصلوا، كما تعلمين.
-ماذا أعددت أيضاً من طعام؟
حملتُ الباذنجان الذي لم تتناوله إلى المطبخ وملأت طبقاً آخر بالفاصولياء وأخذته إليها. عندما فقدت الاهتمام بالفاصولياء وبدأت تبعثرها في الطبق، عدت إلى المطبخ وجلست إلى الطاولة لأستأنف عشائي. بعد قليل، نادتني مجدداً، طالبةً البهار، لكني تظاهرت أنني لم أسمعها. ولكن عندما صاحت «الفاكهة!»، عدت إليها ودفعت بطبق الفاكهة أمامها. فراحت يدها الشديدة النحول تحوم فوقه كما لو أنها عنكبوت مصابة بالدوار. فجأة توقفت وقالت: «كلها فاسدة. أين عثرت عليها؟ هل وجدتها تحت الأشجار؟». فأجبتها: ليست فاسدة يا سيدتي، بل ناضجة. هذه من أجود أنواع الدراق. اشتريتها من بائع الفاكهة. فكما تعلمين، لم يعد في المنطقة أي أشجار دراق.
تظاهرتْ أنها لم تسمعني وانتقتْ إحدى حبات الدراق، فرجعتُ إلى المطبخ وكنت على وشك أن أنتهي من تناول الفاصولياء حين صاحت: «فكّ المحرمة! رجب، أين أنت. فكّ هذه». فهرعت إليها وفيما عملتُ على حلّ عقدة المحرمة، لاحظتُ أنها لم تنهِ أكل حبة الدراق. فرجوتها: «دعيني أقدّم لك بعض المشمش، يا سيدتي، وإلا ستوقظينني نحو منتصف الليل وأنت جائعة». فأجابتني: لم أكن يوماً جائعةً إلى حدّ تناول فاكهة سقطت من الأشجار. شكراً لك!.
فيما راحت تمسح فمها، ظهرت تجاعيد وجهها، ثم ادّعتْ أنها تصلي لبرهة قبل أن تنهض وتطلب مني أن أصطحبها إلى الطابق العلوي. اتكأتْ علي وبدأنا نرتقي الدرج، متوقفين عند الدرجة التاسعة لنلتقط أنفاسنا. فسألتني: «هل أعددت غرفهم؟». أجبتها: «نعم، أعددتها». فتابعت: «إذاً، هيا بنا»، وألقت بثقلها علي. استأنفنا صعود ما تبقى من الدرج، وما إن بلغنا نهايته حتى قالت: «ثماني عشرة، تسع عشرة، شكراً لله». ثم دخلت غرفتها. فسارعت إلى القول: «لنضئ النور لأنني سأذهب إلى السينما». فردت: السينما! أنت رجل ناضج. لا تتأخر في العودة.
عدتُ إلى المطبخ، أنهيت تناول الفاصولياء، وغسلتُ الأطباق. كنت أرتدي ربطة عنقي تحت المئزر. ولم يتبقَ لي سوى إحضار السترة، التحقق من أنني أحمل محفظتي، والانطلاق.
هبّ الهواء البارد المنعش من البحر، فأبهجني. كانت أوراق أشجار التين تصدر حفيفاً خافتاً. أقفلت بوابة الحديقة وسرت باتجاه الشاطئ. وما إن عبرت سور حديقتنا، حتى طالعني الطريق المعبد ومنازل الباطون الحديثة. وقف الناس في شرفات منازلهم وحدائقها الضيقة وراحوا يشاهدون التلفاز، مصغين إلى نشرة الأخبار، فيما انكبت النساء على تقليب الطعام فوق شوايات الفحم. لم يروني بسبب انشغالهم باللحم على الشاويات والدخان. رحت أفكر في العائلة والحياة، متسائلاً عن طبيعة الحياة ضمن عائلة. عندما يحلّ الشتاء، يرحل الجميع. فيتملكني الخوف وأخشى حتى صوت خطواتي في الشوارع الفارغة. ومع هذه الأفكار سرت قشعريرة في جسمي، فارتديت سترتي واجتزت المنعطف.
أذهلني واقع أن الجميع يجلسون إلى طاولة العشاء ويشاهدون التلفاز في الوقت عينه. فيما كنت أسير في الشوارع الخلفية، توقفت سيارة في نهاية شارع يفضي إلى الساحة، وترجل منها زوج متعب عائد من اسطنبول. دخل المنزل وفي يده حقيبة كبيرة، وبدا الاستياء واضحاً على محياه لأنه عاد متأخراً إلى المنزل، ففوت موعد تناول العشاء ومشاهدة التلفاز. عندما رجعت إلى شاطئ البحر، سمعت صوت إسماعيل، وهو ينادي: اليانصيب الوطني، بقيت ستة أيام.
لم يرني ولم أفتح فاهي. راح يقفز بحماسة بين الطاولات في المطعم، فنادته عائلة جالسة إلى إحدى الطاولات، فهرع إليها وانحنى ليقدم بضع ورقات يانصيب إلى فتاة ترتدي فستاناً أبيض وتزين شعرها بشريط. انتقت ورقة بعناية، فيما ارتسمت على وجهَي والديها ابتسامة رضا. أشحت بناظريّ عنه، متعمداً الكف عن تأمله. لو ناديته، لو رآني إسماعيل، لقفز إلي وتساءل عن سبب عدم زيارتي منزله ولأجبته أن منزله بعيد جداً، فهو في أعلى التلة. ولا شك في أن إسماعيل كان سيتابع كلامه، مقراً بأني محق، وموضحاً لي أن كان عليه شراء ملكية هنا قرب الشاطئ، لا في أعلى التلة، عندما أعطاه دوغان بيه المال. ويواصل إسماعيل روايته قائلاً إنه لو اشترى منزلاً هنا قرب محطة القطار لأصبح فاحش السراء. لطالما كرر هذه الكلمات. أما زوجته الجميلة، فما كانت تنبث ببنت شفة، بل تكتفي بالتحديق بك. لمَ علي زيارته؟ أرغب أحياناً في ذلك، خصوصاً في ليالي الشتاء حين لا أجد مَن أتحدث إليه، فأقصده، لكنه لا يكف عن تكرار الكلمات ذاتها.
كانت الكازينوهات عند الشاطئ فارغة. لاحظت أن أجهزة التلفاز فيها مضاءة وأن الرجل، الذي يعدّ الشاي، قد صفّ مئات من الأكواب الفارغة. فأخذت تبرق من شدة نظافتها تحت الأنوار القوية. كان عمال الكازينوهات ينتظرون انتهاء نشرة الأخبار لتتدفق الحشود إلى الشوارع. كانت القطط قابعة تحت الكراسي الفارغة. فتابعت طريقي.
شُدَّت القوارب إلى الجدار في الجانب الآخر من الرصيف. لم ألمح أي طيف على الشاطئ الصغير الوسخ، الذي حطت عليه أعشاب البحر رحالها وجفّت لتختلط مع الزجاجات وقطع البلاستيك… سمعتُ أنهم ينوون هدم منزل إبراهيم «القهوجي»، فضلاً عن المقاهي. انتابتني الحماسة فجأة حين لمحت النور المنبثق من نوافذ المقهى. قد ألتقي أحداً هناك، أحداً لا يهوى لعب الورق، فنتحادث. يسألني عن حالي فأخبره ويصغي، ثم يخبرني هو عن حاله فأصغي. نرفع صوتينا فوق ضجيج التلفاز وضوضاء المقهى. أجد صديقاً، وربما نقصد السينما معاً.
ولكن ما إن دخلت حتى انهارت معنوياتي بسبب الوغدين اللذين سبقاني مجدداً إلى المقهى. فرحا كثيراً حين رأياني وتبادلا النظرات وعلا ضحكهما. لكني لم أنظر إليهما، بل رحت أتأمل ساعتي. بحثت عن صديقي. كان نوزت يجلس إلى اليسار، مراقباً لاعبي الورق. أحضرت كرسياً وانضممت إليه. كنت سعيداً. قلت له: «كيف حالك؟»، لكنه لم يجب.
تطلعت إلى التلفاز قليلاً. كانت الأخبار قد شارفت على نهايتها، ثم تأملت مجموعة الأوراق وهي توزَّع على اللاعبين ونوزت يُلاحقها بعينيه. أردتهم أن ينتهوا من اللاعب، وهذا ما حدث. رغم ذلك، لم يتحدثوا إلي. راحوا يتجاذبون أطراف الحديث في ما بينهم، وارتفعت ضحكاتهم، ثم عاودوا لعب الورق. فصبوا اهتمامهم كله على الأوراق إلى أن توقفوا مجدداً. وفيما كانوا يوزعون الأوراق للبدء بلعبة جديدة، أدركت أن من الأفضل أن أقول شيئاً: «نوزت، ذلك الحليب الذي أحضرته لنا صباحاً ممتاز». فأومأ برأسه من دون أن يرفع ناظريه عن الورق. فتابعت: «يحتوي الكثير من الدسم، إنه جيد». فأومأ مجدداً.
رحت أتأمل ساعتي. كان الوقت قد قارب التاسعة. فرفعت ناظريّ إلى التلفاز ونسيت كل ما يدور من حولي. لكني لاحظت بعد برهة أن الشابين يسخران مني.
وعندما رأيت الصحيفة بين أيديهما، خشيت الأسوأ، ورجوت الله ألا يكون السبب صورة أخرى. فلم يكفّا عن النظر إلي ومن ثم إلى الصحيفة، ضاحكين بخبث. حاولت ألا أوليهما أي اهتمام. لكني لم أستطع منع نفسي من التفكير فيهما. تنشر الصحف صوراً أحياناً غير عابئة بمشاعر الناس، وتدوّن تحتها تعليقات مريعة، تماماً كما حدث حين نشرت صورة سيدة عارية أو دبة تلد في حديقة الحيوانات. وفي خضم موجة الذعر هذه، التفتُّ إلى نوزت وسألته من دون أي تفكير: «كيف حالك؟». فالتفت إلي للحظات، متمتماً كلمات لم أفهمها.
عجزت عن مواصلة الحديث وضاعت الكلمات مني لأن ذهني كان منشغلاً بتلك الصورة. لذلك استسلمت ورحت أراقب الشابين خفية. عندما تلاقت أعيننا، ازدادت تصرفاتهما خبثاً. فأشحت بوجهي عنهما. وقعت صورة ملك على الطاولة، فصاح جميع اللاعبين، كان بعضهم مسروراً، فيما مُنِيَ البعض الآخر بخيبة أمل. بدأوا بعد ذلك لعبة جديدة، وكانت الأوراق والفرحة تتنقل بين اللاعبين، فتساءلت عما إذا كان السبب الأوراق التي تحمل صوراً.
ناديت جميل ليحضر لي كوب شاي. وهكذا وجدتُ ما قد يبقيني منشغلاً لبعض الوقت، لكن ذلك لم يدم طويلاً. لم أستطع منع نفسي من التفكير في ما احتوت عليه تلك الصحيفة وأضحك ذلك الشابين. عندما نظرت إليهما مجدداً، كانا قد أعطيا الصحيفة إلى جميل وراحا يشيران إلى صورة. ولكن عندما لاحظ جميل انزعاجي، نهرهما، قائلاً: وغدان.
باتت سخريتهما واضحة، وما عاد بإمكاني تجاهلها. كان علي الرحيل منذ وقت طويل. أخذ الشابان يضحكان بصوت عالٍ، فقلت لجميل: «ما الأمر؟ ماذا في الصحيفة؟». فأجابني: «لا شيء». حاولت أن أكبح غضبي، إلا أنني لم أستطع لأن فضولي تغلب عليَّ. فنهضت من كرسيّ، كما لو أني في غيبوبة، وتقدمتُ بخطى بطيئة نحو جميل، متجاوزاً الشابين اللذين تسلحا بالصمت. قلت: أعطني الصحيفة.
حاول جميل أن يبعد الصحيفة عن متناولي، فيما راح يتكلم برقة: «مَن يدري إن كان هذا الخبر حقيقياً؟ لم يسبق أن سمعت بأمر مماثل». ثم التفت إلى الشابين والشرار يتطاير من عينيه، وتابع: «وقحان!»، قبل أن يسلمني الصحيفة. انتزعتها من يده كذئب نهم، فتحتها وقلبي يخفق بسرعة. تأملت الصفحة التي كان ينظر إليها، إلا أنني لم أعثر فيها على أي صورة. فقال لي جميل بتوتر شديد: «في الأسفل». خفضت ناظريّ بسرعة إلى الزاوية التاريخية وبدأت أقرأ بصوت مرتفع: «كنوز أسكودار التاريخية: الشاعر يحيى كمال وأسكودار…». ومن ثم انتقلت إلى العناوين «الجنرال محمد»… «المسجد اليوناني»… «مسجد شمسي باشا ومكتبته»… وأخيراً، تتبعت إصبع جميل إلى الأسفل حيث طالعني العنوان: منزل الأقزام في أسكودار.
شعرت بأن الدم تدفق فجأة إلى وجهي، فيما قرأت الخبر بصوت مرتفع من دون توقف: «بالإضافة إلى هذه، ضمت أسكودار ذات يوم منزل أقزام. كان هذا المنزل، الذي بني خصوصاً للأقزام لا الناس العاديين، كاملاً. إلا أن غرفه وأبوابه ونوافذه وأدراجه أعدت للأقزام. وكان على الإنسان العادي أن ينحني كثيراً كي يدخله. ووفق أبحاث المؤرخ الفني الدكتور سهيل أنور، بنت هذا المنزلَ هاندان سلطان، زوجة السلطان محمد الثالث ووالدة السلطان أحمد الأول. أحبت هذه السيدة أقزامها كثيراً، واحتلت هذه المشاعر القوية مكانة خاصة في تاريخ الحريم. أرادت هاندان سلطان أن يعيش أصدقاؤها الأعزاء معاً بسلام بعد موتها. لذلك طلبت من نجار القصر رمضان أسطى بناء هذا البيت. ويُقال إن جمال أعمال الحديد والخشب في هذا البيت الصغيرة حوَّله إلى قطعة فنية. لكن لا بد من الإشارة إلى أننا لا نعرف يقيناً ما إذا كان هذا المبنى الغريب والمثير للاهتمام كان قائماً حقاً، إذ لم يأتِ المؤرخ أوليا جلبي على ذكره، مع أنه جاب أسكودار في تلك السنوات. ولو كان هذا المبنى الغريب موجوداً لاختفى في الحريق الشهير الذي أرعب أسكودار عام 1642.
لاحظ جميل أنني أرتجف، فسارع إلى القول: «انسَ الأمر يا رجب. لماذا تولي هذين الوغدين أهمية؟». اجتاحتني رغبة ملحة في إعادة قراءة هذا الخبر، لكني لم أتحلَّ بالقوة الكافية. كنت أتصبب عرقاً وشعرت أن أنفاسي انقطعت. انزلقت الصحيفة من يدي وسقطت أرضاً. دعاني جميل إلى الجلوس، وقال: «هوّن عليك، لا تستاء. لا داعي للمبالغة». ثم توجه إلى شابين مجدداً، مكرراً: «وغدان». كانا يتأملانني بمكر وأنا أترنح واقفاً على قدميّ. أجبته: «نعم، أنا مستاء». ثم صمتُّ لدقيقة واستجمعت كل شجاعتي وأردفت: لست مستاء لأنني قزم. فالمزعج حقاً أن تُصادف أناساً أشراراً يمكنهم السخرية من قزم في الخامسة والخمسين من عمره.
ساد الصمت. لا بد من أن لاعبي الورق سمعوا ما قلته. تشابكت نظراتنا أنا ونوزت. خفض الشابان أعينهما بعد أن شعرا ببعض الخجل. بدأ رأسي يدور، وشعرت أن صوت التلفاز بدأ ينطفئ. كرر جميل تأنيبه للشابين إنما بحماسة أقل: «وغدان». وما هي إلا لحظات حتى انطلقت مسرعاً نحو الباب. «رجب، إلى أين أنت ذاهب؟». لم أجب. تمكنت ببضع خطوات متأرجحة من الابتعاد عن أنوار المقهى الساطعة خلفي. وهكذا عدت إلى عتمة الليل الباردة المنعشة.
الغُمَّيضة
ما كانت حالتي تسمح لي بمواصلة السير، إلا أنني أرغمت نفسي على القيام ببضع خطوات إضافية قبل أن أجلس على أحد الأعمدة قرب الرصيف البحري. تنشقت عميقاً الهواء النظيف. كان قلبي لا يزال ينبض بسرعة. ماذا علي أن أفعل؟ كانت أنوار الكازينوهات والمطاعم تلمع في البعيد، وقد زينت أشجارها بأشرطة من الأنوار الملونة جلس تحتها الناس لتناول الطعام والتحادث: يا إلهي!
فُتح باب المقهى وسمعت جميل ينادي: «رجب! رجب، أين أنت؟». لم أحرك ساكناً. فلم يرني وعاد إلى الداخل.
بعد برهة، سمعت هدير القطار المتجه إلى أنقرة. لا بد من أن الساعة قد تجاوزت التاسعة. رحت أفكر: كانت هذه مجرد كلمات، أليس كذلك؟ ألم تكن مجموعة أصوات اختفت لحظة التفوه بها؟ شعرت ببعض التحسن، ولم أشأ العودة إلى المنزل. لكن ما كانت أمامي خيارات كثيرة. ما زلت أرغب في الذهاب إلى السينما. فما عدت أتصبب عرقاً وانتظمت نبضات قلبي. شعرت بتحسن، فتنفست عميقاً وتابعت السير.
فكرت في الجالسين في المقهى واستخلصت أنهم بالتأكيد نسوني ونسوا تلك الكلمات، وما زال صوت التلفاز الخافت يختلط بضوضائهم. وإن لم يطرد جميل ذلك الشابين، فلا شك في أنهما يبحثان عن شخص آخر ليهزآ به. وها أنا مجدداً أجوب الشوارع المليئة بالناس، الذين انتهوا من تناول الطعام وتركوا منازلهم للقيام بنزهات قصيرة وهضم ما التهموه، قبل أن يعاودوا الجلوس أمام التلفاز أو يقصدوا الحانات. كانوا يأكلون المثلجات، يمشون، يحيون أحدهم الآخر. لاحظت أن النساء وأزواجهن، الذين عادوا من اسطنبول في المساء، وأولادهم لا يكفون عن المضغ. يلتقون بعضهم بعضاً، فيسارعون إلى إلقاء التحية. مررت قرب المطاعم مجدداً، لكن إسماعيل كان قد رحل. لربما باع بطاقاته كافة وكان يصعد التلة متجهاً إلى منزله. لو خططت لزيارته بدل الذهاب إلى السينما، لجلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث. لكنه لا يكفّ عن تكرار الرواية ذاتها.
كانت الجادة مكتظة. فقد اصطفت السيارات أمام متجر بيع المثلجات، واحتشد المارة في مجموعات من ثلاثة وأربعة، ما سبَّب زحمة سير خانقة. صحيح أن مظهري بدا لائقاً، إذ ارتديت ربطة عنق وسترة، لكني لا أطيق الحشود الكبيرة.
فدرجت إلى أحد الشوارع الجانبية. كان الأولاد يلعبون «الغُمَّيضة» بين السيارات في الشوارع الضيقة تحت الأضواء الزرقاء المنبعثة من أجهزة التلفاز. عندما كنت صغيراً، ظننت أنني قد أبرع في هذه اللعبة. إلا أني لم أتحلَّ بالشجاعة الكافية لأنضم إلى الأولاد في هذه اللعبة، كما إسماعيل. ولكن لو لعبت معهم لاختبأت جيداً، ربما هنا في أطلال الخان، الذي أخبرتني أمي أن وباء اجتاحه، أو في القرية، مثلاً، أو في كومة قش. وإن لم أخرج، ممن كانوا سيسخرون؟ كانت هذه الأفكار تراودني، لكني سرعان ما أتذكر أن أمي كانت ستبحث عني. كانت ستقول: «إسماعيل، أين أخوك؟». وكان إسماعيل سيشد أنفه ويجيبها: «من أين لي أن اعرف؟». كنت سأبقى مختبئاً وأنا أهمس: «أعيش في الخفاء وحدي، يا أمي، أعيش حيث لا يمكن لأحد أن يراني». وحدها أمي كانت ستبدأ بالبكاء بشدة، ما يدفعني إلى الخروج. فأقول لها: «انظري! هأنذا! ما عدت مختبئاً. أنظري! ما عدت مختبئاً يا أمي». وكانت أمي ستسألني: «أين كنت مختبئاً يا بني؟». وكنت سأفكر في أنها محقة على الأرجح. فما نفع الاختباء؟ ما فائدة العيش في الخفاء؟ نسيت هذا الواقع للحظات.
الجريدة